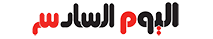برلين تطفئ أنوارها.. لماذا انتكست الحريات في ألمانيا وتعثر اقتصادها؟ | اقتصاد

[ad_1]
في 19 فبراير/شباط 2024 اجتمع رئيس قسم العمليات في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتس، وموظف مركز العمليات الجوية فينسكي وفروستيدت ليناقشوا أسرارا عسكرية خطيرة حول صواريخ تاوروس الألمانية، وما إذا كانت أوكرانيا ستستخدمها قريبا، وأمورا أخطر مثل احتمال قصف الجسر الرئيسي فوق مضيق كيرتش الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم. لم يكن هذا الاجتماع السري منعقدا في مخبأ سري عازل للأصوات، أو عبر تطبيق إلكتروني حصين عصيّ عن الاختراق، وإنما عقده المسؤولون العسكريون على منصة “ويب إكس”.
بعد أقل من ثلاثة أسابيع استمع المسؤولون الألمان الرفيعو المستوى إلى اجتماعهم الذي استغرق 38 دقيقة، إذ نشرته على تطبيق تِلِغرام مارغريتا سيمونيان، الصحفية الروسية الأرمنية ورئيسة تحرير قناة روسيا اليوم، بما فيها النسخة العربية. لم يكن الأمر “فضيحة” كما سمّتها وسائل إعلامية من أبرزها “دويتش فيلة” ذاتها بعد ذلك تتعلَّق بخروج أسرار وخطط حرب تعدها ألمانيا للهجوم على روسيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى فقط، بل لأن الفضيحة كانت في ظهور ألمانيا وهي تعتمد على تكنولوجيا بدائية في مجال الأمن السيبراني، وبعيدة عن مواكبة “العالم المتقدم” في هذا الصدد، ونُظِر إلى ما حدث على نطاق واسع باعتباره مهزلة تكنولوجية وعسكرية.
بعد أقل من شهر من هذه الواقعة التي وصفها مراقبون بأنها “مهينة تكنولوجيًّا”، كانت ألمانيا على موعد مع فضيحة أخرى صنعتها هي بنفسها، فقد منعت السلطات في برلين يانيس فاروفاكيس، المفكر اليوناني ووزير المالية السابق لبلاده، من دخول أراضيها وحظرت مشاركته في أي ندوة تقام داخل ألمانيا ولو عبر تطبيق زوم وما شابهه. والسبب في ذلك هو مواقف فاروفاكيس المناهضة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ومدافعته عن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة احتلال أراضيه.

كان الأمر فضيحة مدوية لألمانيا في مجال احترام حرية الفكر والتعبير بحسب ما يراه مراقبون، فحتى أكثر الدول استبدادا في العالم الثالث ربما تشعر بالحرج من منع مسؤول سابق رفيع المستوى بدولة في الاتحاد الأوروبي من زيارة أراضيها أو حظر أنشطته، لمجرد مخالفته رأي حكومتها بشأن قضية ما، ولعلها تستشعر حرجا أكبر إذا كان مكمن الخلاف أنه مفكر يدافع عن حق شعب مُحتل.
عندما سقط جدار برلين في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٨٩، قال المنظّر السياسي الأمريكي فرانسيس فوكوياما إن العالم بسقوط الجدار لا يشهد نهاية الحرب الباردة، ولا انطواء حقبة معينة من عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، بل نهاية التاريخ، حيث ينتهي تطور أفكار البشر وأيديولوجياتهم، لتسود القيم الغربية، وتصبح الديمقراطية الليبرالية هي الصورة النهائية لشكل الحكومة الذي ينشده بنو الإنسان. بهذه الروح، بدأت ألمانيا عهدها الجديد، لكن خلال جيل واحد، بدا أن ألمانيا قد كشفت عن وجه مخالف لرغبتها في أن تصبح جنة الليبرالية.
مؤخرا، وقبل شهرين من حادثة التجسس الروسي، كان صندوق النقد الدولي قد أعلن صراحة أن الاقتصاد الألماني هو الأسوأ أداء بشكل استثنائي بين الاقتصادات الكبرى العام الماضي. وبحسب موريتس شولاريك، رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي فإن ألمانيا تعاني من “تخلُّف غير مُبرَّر” في قطاعات الرقمنة والبنية التحتية، كما توضح المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد الألماني سيواصل تدهوره هذا العام، بل وصار تعبير “رجل أوروبا المريض” تعبيرا شائعا في التغطيات العالمية مثل تغطيات “سي إن بي سي” وتغطيات “دويتش فيلة” نفسها، لوصف الوضع الاقتصادي الألماني، وهو وضع يعترف به المسؤولون في ألمانيا، وإن كان بعضهم يفضل استخدام تعبير “الرجل المُنهَك” بدلا من “الرجل المريض”.
قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت ألمانيا تحقق أرباحا هائلة جراء المعادلة البسيطة التي ترتكز على شراء النفط والغاز الروسي بأسعار رخيصة، وفي الوقت نفسه لم تكن بحاجة إلى إنفاق عسكري ضخم. وكانت الظروف الدولية تسمح لألمانيا دائما أن تُظهِر نفسها بوصفها الدولة الغنية المتقدمة التي تحترم حقوق الإنسان. ولكن مع الاختبار الحقيقي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، تعرت الحقيقة بما لا يسر الناظرين.
بمجرد أن أصبحت ألمانيا في وضع جديد أفقدها امتيازاتها الاستثنائية السابقة وجعلها تتحرك من موضع خالٍ من المزايا السحرية المسبقة، ظهرت سريعا مأزومية السلطات الألمانية في شتى المجالات. لم تكن الحرب الروسية على أوكرانيا وما تبعها من فقدان ألمانيا لمزاياها الإستراتيجية الاقتصادية التي تمتَّعت بها منذ مطلع التسعينيات، إلا حدثا كاشفا لعطب عميق في نظامها. وبحسب كليمنس فوِيست، رئيس معهد إيفو للسياسات الاقتصادية في ميونيخ، فإن ألمانيا كانت تعاني من نقاط ضعف هائلة في اقتصادها من قبل الأزمة، لكن ارتفاع أسعار الطاقة الذي صاحب الحرب الروسية على أوكرانيا، عجّل بكشف الكثير من العوار في صميم الاقتصاد الألماني، ومنه التراجع الرقمي وكذلك سطوة البيروقراطية والبنية التحتية المتعثرة، فضلا عن ارتفاع معدلات الشيخوخة في المجتمع الألماني ونقص عدد الأيدي العاملة الماهرة، إذ تفتقر أكثر من 40% من الشركات الألمانية إلى الأيدي العاملة التي تمتلك المهارات المناسبة.
لذلك صرَّح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأنه ينبغي لبلاده الشروع في إصلاحات هيكلية في اقتصادها للخروج من الوضع الحالي الذي وصفه ليندنر بأنه بائس. ولعل إحصائية واحدة لديها القدرة على توضيح حجم الأزمة البنيوية في ألمانيا، إذ إن 19% فقط من الأسر الألمانية متصلة بالإنترنت الفائق السرعة عبر كابلات الألياف الضوئية، في حين أن متوسط نسبة الأسر التي تحظى بنفس الميزة في بقية دول الاتحاد الأوروبي هي 56%. وفيما يخص نقص العمالة الماهرة، تشير الأرقام إلى أنه ما من حل قريب يلوح في الأفق لتجاوز الأزمة، غير استقبال المهاجرين المَهَرة. ففي عام 2035 ستخسر ألمانيا 7 ملايين عامل ماهر لتتعمق الأزمة أكثر فأكثر.
جدير بالذكر هنا أن تلك الأزمة تتعلق بمشكلة اجتماعية عميقة في ألمانيا وهي مفهوم الأسرة، إذ سجلت ألمانيا العام الماضي أقل نسبة في الزواجات الجديدة منذ بدء الإحصاء عام 1950، وسجلت أيضا نسبة تاريخية في نقص عدد المواليد الذين بلغ عددهم 693 ألف طفل فقط، أغلبهم لم يكونوا الطفل الأول في أسرة جديدة. ويعني ذلك باختصار أن أزمة النموذج الاجتماعي السائد بألمانيا حاليا ستؤثر سلبا في الاقتصاد الألماني في السنوات القادمة.

وقد تراجع الأداء الاقتصادي في ألمانيا في العام الماضي على نحو أذهل حتى المتشائمين، حيث انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% عن العام الذي سبقه، وتراجعت الصادرات بنسبة 1.4%، كما انخفض إجمالي الإنتاج الداخلي بنسبة 0.3% العام الماضي. ويصف كبير الاقتصاديين في مصرف “بادن فورتِمبِرغ” هذه الحالة بقوله: “نحن نتحرك صوب نوع ما من الاقتصاد المُنكمِش الذي ينمو وينخفض بمعدلات ضئيلة، لكننا في الواقع مُستلقِين على الأرض“.
وعلى الرغم من أن البيانات الصادرة في الربع الأول من عام 2024 تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.2%، وهو أفضل من التوقعات، فإن التشاؤم ما زال مسيطرا على الخبراء والمسؤولين، إذ يرى كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي ومدير وحدة الاقتصاد الكلي بشركة الخدمات المالية والمصرفية “أي إن جي”، أن نقاط الضعف الهيكلية والعميقة بالاقتصاد الألماني لن تختفي في فترة قصيرة، وستعرقل بدورها أي وتيرة انتعاش يمكن أن تحدث في البلاد. وقد شدد كبير الاقتصاديين في البنك التجاري الألماني يورغ كرامر في حوار مع “سي إن بي سي” في فبراير/شباط الماضي، على أن مسؤولي البنك متمسكون بتوقعاتهم التي تقول إن الاقتصاد الألماني سينكمش مجددا بنسبة 0.3% هذا العام.
ولا يعني ما نسرده هنا أن ألمانيا ليست رائدة في صناعات متعددة أو أنها لا تمتلك اقتصادًا من أفضل اقتصادات العالم، فكما يشدد تحليل لشبكة الـ”سي إن إن”، فإن ألمانيا لا تزال قادرة على جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية في الصناعات المختلفة، ولا تزال تفخر بالآلاف من الشركات المحلية العالية الجودة وتفخر بابتكاراتها، لكن ما نسرده هنا باختصار يحاول أن يضع تلك الحقائق في سياق سياسي وجغرافي واقعي من أجل فهم الحالة الألمانية بعمق بما هو أبعد من الأرقام المباشرة والقوالب الجاهزة.
السؤال المُحرَّم: هل يعمل الشعب الألماني بجدية؟

في العالم العربي تستخدم كلمة “ألماني” لوصف الشخص الجاد في عمله والمنظم والمنضبط في مواعيده، الذي لا يعرف الكسل ويتسم بالحزم والإصرار على إنجاز مهامه بأعلى درجات الإتقان، ولطالما التصقت كلمة ألماني بصفات إيجابية في المخيال العالمي بشكل عام، ولكن البيانات الجديدة التي تكشفها الكثير من المصادر ومن أبرزها بلومبرغ تظهر عكس ذلك. إن أحد الأسباب الأساسية لسقوط البلاد في الركود راجع إلى المعدل الكبير للإجازات المرضية التي أخذها العمال الألمان العام الماضي، بمتوسط 15 يوما في العام. وجدير بالذكر هنا أن الكثير من تلك الإجازات كانت لأسباب نفسية وليست لأسباب عضوية واضحة تعوق عن العمل، فضلا عن تحول الكثيرين إلى العمل بالدوام الجزئي، ففي عام 2023 كان متوسط ساعات العمل السنوية في ألمانيا لكل موظف ثاني أسوأ معدل مسجل في البلاد بحسب بلومبرغ.
لقد دفعت الإجازات المرضية التي أخذها الألمان والرقم القياسي الذي أحرزته العام الماضي، مؤسسة بلومبرغ إلى التندُّر بالقول إن “ألمانيا رجل أوروبا المريض حرفيا لا مجازا”. وتُظهِر البيانات فعليا أن الموظفين الألمان هم الأقل اجتهادا بين كل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (منظمة الدول التي تصف نفسها بأنها ملتزمة بالديمقراطية واقتصاد السوق)، وهم الأقل اجتهادا وفقا لمؤشر عدد ساعات العمل الفعلية لكل موظف، وكذلك وفقا لمؤشر عدد ساعات العمل الفعلية لكل ساكن بالغ.
بحسب بلومبرغ، فإن الساسة الألمان بدؤوا يكسرون تابو الحديث عن المواطن الألماني بوصفه كسولا، وبدؤوا يقولون بوضوح إن شعبهم لا يعمل بالقدر الكافي. فقد قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن الإيطاليين والفرنسيين وبقية أوروبا يعملون أكثر من الألمان، وحتى ممثل حزب الخضر وهو وزير الاقتصاد والبيئة روبرت هابِك أعرب عن تذمره من إضرابات العمال المتكررة في ألمانيا، التي لم تعُد تتحملها الدولة على حد وصفه.
إذا ما حاولنا أن نلخص هذا الأمر ببساطة، فإن المزايا التي حصلت عليها ألمانيا قبل الحرب الروسية على أوكرانيا المتمثلة في الطاقة الرخيصة، ومكَّنتها من توفير بيئة مستقرة لقطاع صناعي متطور له العديد من الزبائن في الخارج، أعطتها فرصة لتوفير مزايا استثنائية لطبقتها العاملة جعلت العامل الألماني يتمتع بـ30 يومَ إجازة مدفوعة الأجر سنويا في مقابل 15 يوما للعامل في الولايات المتحدة على سبيل المثال. ولذلك، تشير البيانات إلى أن المواطن الألماني يعمل أقل نسبيا من أقرانه في العالم خلال فترة حياته.
ولكن بعدما تغيَّرت الظروف الجيوسياسية وانكشفت المشاكل الهيكلية بالاقتصاد الألماني، لم يعد العامل الألماني يتمتع بذلك الوضع الحمائي الذي جعله يعمل أقل من أقرانه في الدول الأخرى وينتج أكثر منهم ويحافظ على صورته بوصفه مرادفًا للاجتهاد والإتقان والتفاني. والآن أصبحت القيادات الألمانية نفسها هي من يلوم هذا العامل على كسله من وجهة نظرها مقارنة بأقرانه.

وداعًا لحرية التعبير
“ما الشيء الذي يمكن أن يجمع بين فرقة مسرحية أيرلندية، ومهندس معماري بريطاني، ومصور بنغالي، ومؤرخ أمريكي، وملحن من تشيلي، وكاتب مسرحي إسرائيلي، ولاعب كرة قدم هولندي، وصحافي نيجيري، وروائي فلسطيني، وفنان جنوب أفريقي؟ الإجابة أن كل هؤلاء محظورين من قبل ألمانيا في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب موقفهم المناهض لإسرائيل”. مجلة الإيكونيميست، تعليقًا على قمع ألمانيا للتضامن مع فلسطين
قبل عام 2023 كان بإمكان ألمانيا دائما أن تعطي محاضرات لبقية العالم عن احترام حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان. كفلت الظروف الدولية والحياة المريحة في ألمانيا لبرلين أن تظهر دائما بصورة جنة الحريات. ولكن، مرة أخرى، تعرَّضت البلاد لاختبار جديد سياسي هذه المرة لا اقتصادي. ففي نهاية العام الماضي، ومع اندلاع عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من غزو بري لقطاع غزة من جيش الاحتلال، دخلت البلاد اختبارًا صعبًا يمتحن عمق التقاليد الديمقراطية والحريات فيها.
فمن المعروف أن ألمانيا مرتبطة ارتباطا عضويا مع دولة احتلال استيطاني هي إسرائيل، التي تشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني الذي تحتل أراضيه، وكانت تحاول في بعض الأوقات أن تكون أكثر رصانة، ولكن الآن تلاشت أي رتوش تجميلية، وفي نفس الوقت توجد داخل ألمانيا قطاعات لا بأس بها من المقيمين والمواطنين الذين يرفضون الاحتلال ويعترضون على المساعدات التي تقدمها ألمانيا لدولة الاحتلال، وتوظف في عملية إبادة وتشريد شعب آخر، فماذا ستفعل جنة الحريات إذن مع هؤلاء المعترضين؟
لقد ذهبت ألمانيا أمام مناهضي الاحتلال من مواطنيها وسكانها إلى مدى قد تخجل منه أنظمة دكتاتورية، فمنذ انطلاق موجة المقاومة ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الثاني 2023، قيَّدت برلين المسيرات المؤيدة للقضية الفلسطينية، وجرَّمت هتافات يكفل القانون الألماني نظريًّا الحق في الهتاف بها، ومنحت المدارس سلطة حظر الأعلام الفلسطينية والكوفيات، ولم يخجل مسؤولوها على اختلاف مشاربهم من أن يؤكدوا أن أمن دولة الاحتلال هدف دولتهم الأسمى، وأنه أمر غير قابل للنقاش. في ظل هذا المناخ اعتدت قوات الشرطة الألمانية على نشطاء ألمان في الشوارع بسبب هتافهم “فلسطين حرة”، ووصل الأمر إلى حد الابتزاز بأوراق الإقامة لداعمي القضية الفلسطينية.
في غضون الشهور الماضية -بحسب ما سجل حقوقيون- أصبح سِجِلّ ألمانيا ممتلئًا عن آخره بفضائح انتهاك حرية التعبير. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2023 انتهاكات ألمانيا بشأن حق التجمع والتظاهر السلمي، فضلا عن استخدامها المفرط للعنف في التعامل مع التظاهرات، والقيام بمئات الاعتقالات. وتحدثت المنظمة في تقريرها أيضا عن “غياب آليات مستقلة لتقديم الشكاوى مما يحول دون تحقيق المساءلة بشأن الانتهاكات التمييزية التي ترتكبها الشرطة الألمانية”. وبعيدا عن قمع الاحتجاجات المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني الذي تساهم في احتلاله وإبادته وتشريده منذ عقود، وبعيدا عن القسوة المستخدمة ضد تلك الاحتجاجات التي وصلت إلى حد منع المقبوض عليهم فيها من قضاء حاجتهم في الحمام أو الاتصال بمحاميهم، فقد وصلت ألمانيا إلى مستوى آخر من قمع حرية التعبير حين دخلت الشرطة الألمانية في أبريل/نيسان الماضي، فقطعت الكهرباء ومنعت مؤتمرا يضُم قامات فكرية كبيرة لأن المؤتمر مناهض لدولة الاحتلال.
وقد منعت السلطات الألمانية حينها الجراح البريطاني ورئيس جامعة غلاسكو الأسكتلندية غسان أبو ستة من دخول أراضيها للمشاركة في المؤتمر، وقطعت الكهرباء عن المؤتمر ومنعت بقية فعالياته حين شارك فيه غسان عبر تطبيق زوم. ليس هذا فحسب، بل فرضت ألمانيا حظرا على غسان من دخول دول الشِنغِن بمعنى تعرضه للقبض عليه فورا حين تطأ قدماه أرضا أوروبية. وقد علقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على ما حدث بأنه كان تدخلا صائبا وضروريا من الشرطة. وقد اكتملت المأساة الألمانية حين أصدرت السلطات حظرا مشابها على يانيس فاروفاكيس، بسبب تأييده لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة محتليه، وردَّ المفكر بدوره قائلا إن ألمانيا تفضح نفسها بأفعالها على المستوى الدولي، وإنها تسحق حرية الرأي والتعبير.
أسقطت حرب غزة القناع عن وجه ألمانيا، التي أصبحت في نظر الكثيرين دولة إمبريالية تشجع على احتلال أراضي الشعوب الضعيفة، وتساند الإبادات الجماعية، وقد أزالت سياساتها الأخيرة كل مساحيق التجميل التي وضعتها على وجهها لأكثر من نصف قرن، وهو ما عبَّر عنه ببراعة الرئيس الناميبي هيج جينجوب حين تدخلت ألمانيا لتدافع عن دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية لاتهامها من قبل جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية في غزة، إذ قال: “لا يمكن لألمانيا التعبير أخلاقيا عن التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، بما يتضمنه ذلك من التكفير عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ألمانيا في بداية القرن العشرين بناميبيا، وفي الوقت نفسه تدعم إسرائيل”.
وقد رفعت نيكاراغوا قضية في محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادات الجماعية من خلال إرسالها المعدات العسكرية لدولة الاحتلال، وقد زاد هذا الطين بلَّة بعد أن خرج سبعة من مقرري الأمم المتحدة وأعلنوا في فبراير/شباط 2023 عن بالغ قلقهم بشأن نقص التدابير التعويضية الفعالة الممنوحة من قبل برلين للشعوب التي أبادتها ألمانيا في بداية القرن العشرين بناميبيا. هكذا بدت ألمانيا في العام المنصرم بوجه جديد كدولة يرتبط حاضرها كما ارتبط تاريخها بالإبادات الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.
إن ألمانيا قبل السابع من أكتوبر/تشرين الثاني 2023 لم يكن لديها أي اختبار حقيقي يمتحن قدراتها الديمقراطية والحقوقية، فكانت تقدم نفسها للعالم باعتبارها نموذجا للعالم الحر، لكن مع الاختبار الأول انكشفت العورة المختبئة، وهي أن النظام الديمقراطي في ألمانيا منذ أن نشأ بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن في جوهره ديمقراطيا.
لقد عرفت ألمانيا ديمقراطيتها على أنها “ديمقراطية حصينة” كنقيض لنموذج الديمقراطية الليبرالية الأنغلوساكسوني، وهذه الديمقراطية الحصينة تعني باختصار أنه يمكن للدولة تعليق بعض الحقوق المدنية وانتهاك الحريات ما دام ذلك يصُب في خدمة الديمقراطية على المدى البعيد. ومن ثم يمكن باختصار للدولة الألمانية أن تعقد نظرية سطحية تفيد بأن قمع المناهضين لدولة الاحتلال يعني الحفاظ على الديمقراطية الألمانية على المدى البعيد ومن ثم فهذا قمع مسموح به. المفارقة أن الغرض من صياغة النظام الديمقراطي الحصين على هذا النحو بدءا من عام 1952 كان عرقلة أي صعود جديد للنازيين، لكنه على أرض الواقع كان يُطبَّق على العكس من ذلك، ضد اليساريين ومناصري قضايا العالم الثالث. فقد استخدم من أجل حظر الحزب الشيوعي الألماني، في وقت كان النازيون السابقون فيه يشغلون مناصب مرموقة في الإعلام الألماني والسياسة. والآن تستخدم تلك “الديمقراطية الحصينة” لقمع كل الأصوات المناهضة لدولة الاحتلال والمدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني وسط ترحيب كبير من النازيين الجدد في الأحزاب اليمينية المتطرفة الذين يكرهون المسلمين ويشجعون الإبادة الجماعية في غزة، وهكذا فإن النموذج الاستبدادي الذي يسمى “الديمقراطية الحصينة” وتتبعه ألمانيا لم يستهدف النازيين إلا قليلا على مدار تاريخها، لكنه استُخدم لصالحهم كثيرا.
Source link